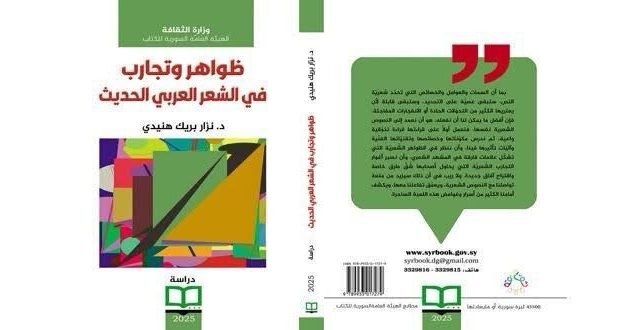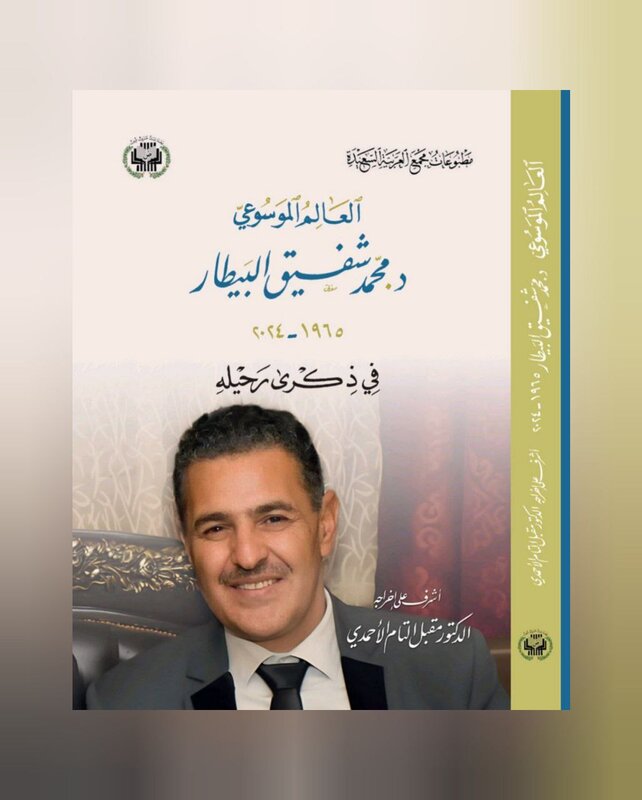أفضّل قراءة الروايات الحديثة بعد فترة من صدورها، حيث تتحول إلى مناسبة للعرض والإخبار، وتفسد القراءة السريعة مادتها بالاختزال. الرواية الجديرة تحتاج إلى قراءات متأنية، ويفضل أن تكون بمعزل عن معرفة المؤلف، لتصبح العلاقة بالنص خالصة، بعيدًا عن شروط إنتاجه. هذا ما شعرت به تجاه رواية "غيبة مي" لنجوى بركات، التي عرفتها من خلال "باص الأوادم" بقدرتها على تجميع طباع وشجون وعلاقات في فضاء مكثف وسرد واقعي ذي رهافة شعرية.
لا ينبغي أن نمل من تكرار أن الرواية العربية استفحل كمها وهزل مبناها، وأصبحت قولًا في غير ما لفنه وغرضه تكتب. هذا وعي تستخلصه مبكرًا من قراءة عمل نجوى بركات الذي أرادته جمعًا لمفردها، ومفردًا ذاتيًا، إذ ينحت ملامح شخصيتها العاملة، وبحثها يرسم بانوراما عالم ينهار بانهيارها. هنا عليك أن تفهم أن لا رواية حقيقية ناضجة من دون رؤية للعالم تصدر عنها وتجسدها.
توجد الحكاية، بل الحكايات، فالرواية تتحقق جنسًا أدبيًا بصنع بنيتها السردية. الرواية تأخذنا في رحلة إلى شقة في الطابق التاسع من عمارة في بيروت، حيث تعيش امرأة في الرابعة والثمانين، تحمل سيرة طويلة مليئة بالخبرات والتجارب.
اختارت الكاتبة طرائق مختلفة للسرد، تبدأ من مشارف النهاية، من أفول الشخصية، بتساوق وانسجام تام مع أفول المدينة حيث تعيش. من هذه المشارف تمارس أربع إطلالات منتظمة: الأولى، من شرفة شقتها على العالم الخارجي (بيروت). الثانية، بتفقد جنبات الشقة. الثالثة، عبر شخصيات ثانوية. الرابعة، حين تؤوي إلى ذاتها فتستدرج ذكريات ماضيها الشخصية والعائلية، وبذا نتعرف إلى سيرتها، وكيف وصلت أو تدحرجت من أمس إلى اليوم، فهي في طور الهاوية؛ تستغرقها أسئلة كبيرة عن الحياة والوجود ذات طبيعة فلسفية عامة جزء منها إسقاط من المؤلفة لإلباس روايتها بردًا فكريًّا يرقى بقصتها فوق مجرد مصير امرأة عجوز، وذلك بطريقة خليط بين المونولوغ الداخلي والصيغة التقريرية.
هذه الإطلالات، مقدمات لقصة أرادت لها مؤلفتها أن تتأشكل، فتصبح أكثر من أعراض ما يلحق بمن يتقدمون في السن من عجز وخرف وفقدان للذاكرة، فتنتقل بالأحرى تستعيد خيط الاستهلال الذي قدمها في دوامة قلق وتوجس من وجود دخيل في شقتها إلى حد استدعاء المساعد يوسف إلى الشقة يبحث عن الغريب المفترض فلم يجد أحدًا، إذ كيف سيعثر على شبح هو مي شخصيتها نفسها، تستحضره لاحقًا امرأة تجالسها وتروي لها حكايتها في شبابها، بنوع من التضعيف والطي، لقصة داخل قصة.
يتجسد الشبح المفترض في صوت سيسرد طويلًا الوجه الخلفي لشخصية مي، إبان شبابها قبل ما بعد الثمانين، وقصة أخرى ربطت بعسر مع ما تقدمها يمكن أن تستقل بذاتها، فيما أرادتها الكاتبة أرضية صلبة عليها قام بناء سيرة الشخصية واستفحلت وحدثت زلازل حياتها. باختصار، الشابة التي أهلتها موهبتها لاحتراف التمثيل والنجاح فوق الركح، والارتباط بشاب مخرج يبحث عن التعبير والشهرة ويتقمص هيئة اليساري البوهيمي، ستعيش قصة حب عنيفة وشرسة بين مد وجزر في مناخ بيروت ستينية فنية زاهرة. وتعرف أحداثًا بسيناريوهات ميلودرامية بطلتها دائمًا مي تعاني عذابات مريعة من رفيقها تنتهي بمحاولتها حرقه وجراء ذلك إيداعها مستشفى المجانين، ثم بلوغها النهاية السعيدة بارتباطها بالطبيب المعالج الذي ستنجب منه توأمين لن تربيهما لإصابتها بالزهايمر سنوات. ثم وفاة الزوج المصادفة، وهجرة الولدين إلى الخارج وبقائها وحدها تطل من شرفة شقتها في الطبقة السابعة على مدينتها بيروت تتدهور وتنهار بتواز مع انهيارها هي.
بذلت نجوى بركات جهدًا حكائيًا مسهبًا لتختصر السيرة الوطنية والاجتماعية والسيكولوجية لبلد يعيش منذ خمسة عقود تراجيديا تفككه وانهياره المتواصل، والرواية اللبنانية سجل واقعي تصعيد لها لا تتفوق عليها أهوالًا وضراوة بقدر ما تؤزمها في عقد وحبكات وتمثيلات عصابية. أجد في ما سردته وشخصته، تخيلنته نجوى بركات في روايتها الأخيرة نهاية جناز طال واستطال فلا توجد رواية عربية يتوحد فيها مصير الإنسان ومساره والمكان مثل اللبنانية، وإن كانت المأسوية روحًا شعرية أولًا، لذلك يأتي سردها متفاوتًا، مذوتًا بشدة وجريحًا، مدموغًا بملامح كتابه تسحبه إلى ناحية التخييل الذاتي أكثر من مقتضى السرد الموضوعي. في هذه الرواية جمعت بركات الأشلاء وكتبت بالرمم، ووحدت البديع بالشنيع، القبح بالجمال، وأوصلت مدينتها، وحيوات ناسها، ومعضلات وجودهم وجودها، بعد تلكؤ، وتذبذب، بين سيناريوهات وأوهام بإمكان البقاء، إلى حتمية الفناء والمحو النهائي، فقدان الذاكرة والإيداع في مستشفى الأمراض العقلية. جو طبع كتابة العمل، تفكك بعض أوصاله وتجاور حتى تنافر طرائق سرده، مع تعدد الخطابات وتضاربها، وإجمالًا فسيفساؤه النصية المصنوعة بقطع وخطوط وألوان ليست منسجمة دائمًا عندي انعكاس لواقع نسقه هو التفسخ، وإن عاند للبقاء فإنه فقد الروح وذهب إلى الزوال مثل غادرت مي بأبهة.
في تاريخ الرواية ثمة مراحل مفصلية، مكوناتها الزمن، وتطور المدنية، وتغير الصراع، وأزمات الإنسان الفرد وأحلامه ومطامحه وخيباته، وأساليب تلتقي في تركيب رؤية العالم ووعي الذات، بل ينبغي، وهذا ما يدفع الرواية نحو التطور والتحول، حين تصل إلى ذروة ما ونفاد الزاد. أختصر لأقول، بعد "غيبة مي" ينبغي لكتاب الرواية في لبنان أن يبحثوا عن مادة أخرى وتخييل مختلف، وإلا فلن يكتبوا، هم وعرب آخرون، إلا التكرار كما يفعل أكثر من واحد بملل وإسفاف عقيمين ومضجرين، ولا يفيد الضجيج وعجيج المناسبات. لو لم يكن لرواية نجوى بركات إلا التنبيه الى هذا وحده لعدت ذات فضل عظيم، وضرورية؛ وإنها لكذلك.